- ٢٧ نيسان/أبريل ٢٠٢٤ | ١٨ شوال ١٤٤٥ هـ
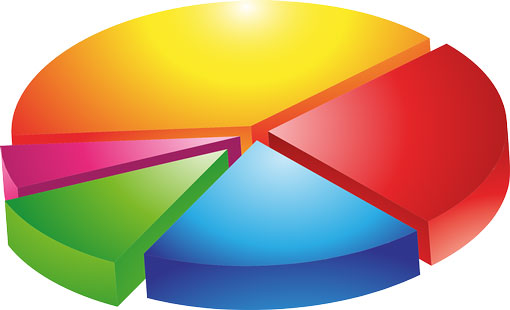
تقدم الدول الإسلامية، على الصعيد الاقتصادي المحض، تشابهاً واختلافات جمة. النقاط المشتركة تحددها العلاقات التي تقيمها كبلدان من العالم الثالث مع العالم الصناعي. وبالمقابل وفي نفس الوقت، فكلّ بلد منها له خصوصياته والتمايزات لا تفتأ تزداد، وهي محكومة بعوامل موضوعية مثل الأهمية السكانية، المبلغ الإجمالي للدخل القومي موزعاً على كلّ ساكن، معدل النمو الاقتصادي، امتلاك المواد الأولية، الانفتاح على السوق الدولية ودرجة التبعية إزاءه... إلخ. من السذاجة إذن عدم الاهتمام بسعة وتنوّع العالم الإسلامي المعاصر. من شأن إعداد إستراتيجية تنمية موحدة أن يثير عراقيل من الصعب تخطيها.
لقد أفلست النماذج الاقتصادية المستوردة مهما كانت مصادرها وألوانها الأديولوجية. ولم يعد الارتفاع المزعوم لمعدلات النمو يخدع أحداً. والبون بين البلدان الغنية والفقيرة ينزع إلى الاتساع بدلاً من التقلص. فضلاً عن أنّ النماذج أو المؤشرات التي أعدت في الخارج، هي تتمة لأدوات الاغتراب الثقافي التي تحاول شريحة متزايدة من الرأي العام الإسلامي رفضها، لا بدافع التقوقع أو كره الأجانب، بل قناعة بأنّ العودة إلى المبادئ الأصلية للثقافة التقليدية بإمكانها أن تحرك بواعث نفسية ضرورية للمجهود الاقتصادي. يندرج هذا السعي وراء نظام جديد ضمن التيار العريض للبحث عن الأصالة. الإسلام الذي هو دين وثقافة وشعوب خرجت من الحقبة الاستعمارية وشرعت تواجه مشكلات اجتماعية ـ اقتصادية هائلة، هو الذي يزعم على نحو ربما بدا غريباً في نظر الملاحظ الأجنبي السطحي، القدرة على الهام الطرق القادرة على تحويل المجتمع.
مازال التصنيع حالياً، وإلى حد كبير، تحت رحمة القرارات الأجنبية، أعني إرادة البلدان الأكثر تقدماً في تسليم التكنولوجيا والتخلي عن جزء من تخصصها. نقل التكنولوجيا مشؤوم، في جميع الأحوال إذا لم يترتب عنه خلق العمالة أو إذا كان هدفه الأساسي تصدير التلوث التكنولوجي من الدول الصناعية إلى بلدان العالم الثالث. وفي ذات الوقت، فإنّ البون الذي يفصل بين وجهات نظر ومطامح كلّ من البورجوازية البيروقراطية والسكان الريفيين في كثير من البلدان الإسلامية يؤخر التنمية الزراعية ويزيد من التبعية الغذائية التي يمكن أن تشكّل على المدى البعيد، سلاحاً سياسياً حقيقياً في متناول بعض الدول الكبرى. وأخيراً فإنّ غياب التماسك في الإستراتيجيات، وخاصّة في الاستثمارات الصناعية، تترتب عنه نتيجة سلبية مزدوجة، زيادة التبعية التكنولوجية، المالية والإِدارية وحث العقول الأكثر جدارة على الهجرة. هذه الأخيرة، ليست داء يصيب الكوادر، الجامعيين وحدهم، بل يمتد إلى اليد العاملة، الماهرة وغير الماهرة، التي تغادر بلدانها إلى أوروبا، لأنّ حكوماتها لم توفق في اختيار التقنيات التي تتطلب عدداً كبيراً من العمال، لصالح مشروعات قائمة على درجة عالية من كثافة رأس المال.
يتطلب تغيير المنظور الذهني، زيادة على عامل الزمن، مخيلة ملتصقة بالواقع. هذا المشروع، الجنيني والجديد، ضروري. ولن يكون مفيداً للأُمّة الإسلامية وحسب، بل أيضاً لمجموع الاقتصاد العالمي، لأنّه لم يعثر بعد على أي معيار كمي لقياس الاتجاهات الاجتماعية ـ الثقافية وتأثير القيم الروحية على المحيط الاجتماعي ـ الاقتصادي. قد يشكل الموازن الثقافي للتأثيرات الخارجية، نظراً للخور العام للاقتصاديات وللهشاشة النسبية للمؤسسات السياسية، القلعة الأولى الحامية للتنمية الاقتصادية. مبادئ الإسلام الاقتصادية لم تدرك حتى الآن إلّا عبر إسهامها بالقوّة في ظهور نظام جديد، لكنّها لم تلهم بعد أعمالاً خلاقة في منظور "تحديثي". أنّ العالم الإسلامي، بعد أن جرب شتى الأيديولوجيات العلمانية "العالم ثالثية" يعبأ الآن نفسه تدريجياً حول الإسلام للقيام بحملة جديدة.
المرحلة الانتقالية بدأت تقريباً. كلّ مرحلة خلق تنطوي على مخاطر. وفي وضع تطوري أكثر مما هو ثوري، يتطلب انتقال المثل العليا إلى إطار نظري ملموس ـ حضره أُناس يستحثهم الوقت وتتحكم فيهم الأولويّات ـ ثم إلى الممارسة اليومية، وضعها موضع التطبيق تدريجياً. هذه المرحلة التي يتم فيها إدخال النظام الاقتصادي إلى الإسلام دقيقة، إذ أنّ بإمكانها أن تبدو معارضة لجوهر الثورة نفسه: الشمول. على أية حال، لابدّ من القيام بخيارات حذرة لتمييز الجوهري من العرضي، اجتناباً لنوع ثانٍ من تجزئية المؤسسات، ولتأمين الدعم الشعبي بانتظام. ستكون فترة الانتقال هذه مهددة بالتوترات التي تؤثر في النظام الاجتماعي ـ السياسي، الذي صادرته البورجوازية البيروقراطية لحسابها الخاص، هذه الطبقة التي كثيراً وغالباً، ما كانت خلال العقود الأخيرة، سبب خلل واضطراب لا محركاً للتنمية. بيد أنّ الزمن لا يرحم، لأنّ عناصر الخطر تتزايد. ورفاهية الجيل الصاعد رهن بتحديد فوري لإستراتيجية سديدة. وفي نفس الوقت بدأت تتجلى تطلعات أوسع الجماهير للحصول على نمو اقتصادي متواصل، يؤمن مستوى لائقاً من الاستهلاك، عمالة كاملة وتوزيعاً كامل المساواة للثروات القومية. ينبغي العثور على حل وسط بين المطلب الفوري والتخطيط المتوسط المدى، لكي تمتص التحويلات البنيوية ولكي لا تقود إلى العماء. ليس بوسع ديناميك توازن جديد أن يثبت أقدامه إلّا ببطء. وبالإمكان أن يكون له تأثير تسريع تجميعي إذا نجح في فتح الطريق تدريجياً لعودة العقول ورؤوس الأموال الإسلامية المشغلة حالياً خارج الأُمّة.
في النهاية، يدور كلّ النظام السياسي ـ الاجتماعي الإسلامي حول العدل، وهي عاطفة غير محددة بالتأكيد، لكن القرآن والسّنة شرعا لتحقيقها: كدالة الملكية الخاصّة، لكن أيضاً "الإصلاحية" لإعادة توزيع رأس المال لمصلحة المستضعفين. فعلى الدولة الإسلامية أن تشكل أُمّة الرفاهية المادّية والروحية، ضمن روح الخدمات والتآخي، القائم على تنظيمات قانونية وضرورات أخلاقية. وجرّب المساعدة المتبادلة نص عليها في الصحيفة، الاتفاق الذي أجراه محمّد عند حلوله بالمدينة: "وكلّ طائفة منهم تفدي عانيها بالمعروف والقسط بين المؤمنين". أو أيضاً "أنّ المؤمنين لا يتركون مُفَرحاً بينهم أن يعطوه بالمعروف في فداء أو عقل".
يتميز الإسلام جوهرياً، على صعيد المذهب الاقتصادي والاجتماعي، من الأيديولوجيات المعاصرة. فالسيادة السياسية فيه وكذلك ملكية جميع المنافع الأرضية لا تعود إلّا لله، والله وحده. فالإنسان لا يملك إلّا حقّ الانتفاع. التوزيع ليس متساوياً إذ كما يقول القرآن: (إِنَّ الأرْضَ لِلَّهِ يُورِثُهَا مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ) (الأعراف/ 128). الملكية الخاصّة معترف بها ضمنياً، لكنّها ليست "حقّاً" بقدر ما هي "وظيفة". شرعيتها مشروطة بطريقة اكتسابها ـ عمل، هبة أو ميراث ـ وباستعمالها، السليم واللائق. وهي تفقد شرعيتها إذا تناقضت مع المساواة الاجتماعية، أو أدت إلى احتكار الثروات العامّة الذي يفصم عرى الوحدة الاجتماعية ويسهل استغلال الأغنياء للضعفاء. التزام الدين الحاسم بتنظيم الحياة الاقتصادية من شأنه أن يكفل للفرد استقلاله وأن يقيم حواجز ضد التجاوزات. فما يهم الإسلام ليس الاضطلاع مباشرة بتنظيم المجتمع بقدر ما يهمه فرض بعض القيم الأخلاقية لحماية الصالح العام وكفالة الحقوق الفردية. الأوامر إلهية واضحة تماماً بهذا الخصوص: لا ينبغي أن تكون الثورة دولة بين الأغنياء. ويشير القرآن أيضاً بأنّ المتقين يدخلون الجنّة، لأنّ: (وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ) (الذاريات/ 19).
زيادة عن الأوامر الأخلاقية والالتزامات الدينية، فرض القرآن أيضاً، وربما لأوّل مرة في التاريخ، نظاماً جبائياً راقياً: الزكاة التي بها توزع الثروة داخل الأُمّة. مع تطوّر الدولة الإسلامية، أخذت الزكاة صورة "ضريبة" حقيقية بيد أنّ أداءها ظل يمثل ممارسة روحية ـ مثل "أركان" الإيمان الأخرى ـ تدفع المؤمنين إلى الارتفاع فوق الأعراض المادّية، لصالح الإيثار والتضامن الاجتماعي. مقدار الضريبة محدد بدقة، يقارب 2.5% من الثروة القائمة منذ عام على الأقل. مستحقوها الشرعيون معيّنون بدقة: المساكين، الأرامل، اليتامى، المدينون المعسرون، العبيد الراغبون في العتق، المؤلفة قلوبهم، الجُباة، المسافرون وأبناء السبيل. الزكاة، كعمل صالح، تشهد على الرغبة في إعادة جزء من إحسان الله العظيم إليه وتبيّن عملياً واجب العدل. فالزكاة تزكي كما أمر القرآن: (خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا) (التوبة/ 103)، وهكذا فهي تجعل امتلاك الأموال التي أخذت منها حلالاً. وبما أنّها واجبة وشرعية، فهي تفقد، عندئذ، المظهر المذل أحياناً ل"الصدقة" بالنسبة لمن يأخذها.
بالإمكان تلخيص فلسفة الإسلام الاقتصادية، في خصوصيتها، بآية قرآنية وحيدة: (وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الآخِرَةَ وَلا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا) (القصص/ 77). وبعبارة أخرى، يُشجع المسلم على الاستمتاع بمتاع الدنيا، طالما امتثل للأوامر الإلهية. ديناميكية التقدم تُتجاوز فقط بالواجب الأخلاقي. فالرفاه المادّي والإصلاح الروحي يشكلان، معاً، السعادة الإنسانية بيد أنّ الاقتصادي مطوّع بوضوح للأخلاقي. ولابدّ من أن تكون التصرّفات الفردية السياسات الحكومية التي تمس الإنسان، المجتمع والعالم محددة بهذا الاعتبار أيضاً. تقبل الأخلاق أو ترفض شرعية أهداف التنمية وتحكم على مضمون الإستراتيجيات التي تم تبنيها. لا يمثل رفضها للمادّية الخالصة الطريق الأسهل. لكنّها تبدو مع ذلك، بفرضها منظوراً واسعاً، يشتمل على عدة أبعاد متكاملة، متطابقة مع ما نعرفه من التطور الاجتماعي، بفضل دارسة التاريخ العام.
الواجب الذي فرضه الإلزام الأخلاقي على الأُمّة الإسلامية لا يجعل منها إطلاقاً مجتمعاً رجعياً يدير وجهه للماضي، لأنّ القرآن يحث صراحة وباستمرار المؤمنين على التفكير في الآخرة والتمتع في نفس الوقت بمتاع الحياة الدنيا. أوضاع العالم الإسلامي المعاصر ليست حجة مقبولة لاعتبار الدين، كدين، مسؤولاً عن أسباب التخلف الاقتصادي. بل العكس، فخور الأنظمة الاجتماعية الواضح هو، تحديداً، الذي أدى إلى نهضة فكر إسلامي.
إذا تحوّل التفاوت إلى حيف وعقبة في وجه الإبداع، جاز عندئذ للدولة الإسلامية بأن تتدخل استبدادياً. فاختصاصها واسع جدّاً، لأنّ سلطتها تمتد حتى إلى تسويق سلع الاستهلاك. لا شيء، من حيث المبدأ، يدفعها لتنمية قطاع مؤمم طالما ليست المبادرة الفردية حاجات السكان الفعلية، وتوفر العمالة الضرورية وتوزع الدخل القومي بعدل. تمتلك الدولة، بمفهومها الكلاسيكي، اختصاصات واسعة وفي الوقت ذاته، سلطة تقتصر على ترجمة المقاييس الأخلاقية إلى ضوابط تنظيم اجتماعي عينيّة.
إستراتيجيات التنمية الاقتصادية التي أُدخلت إلى البلاد الإسلامية لم ينجم عنها تحويل البُنى الاجتماعية. الثورات التي جدت فيها غيرت المؤسسات والأشخاص لكنّها لم تغير المجتمع. كما أنّها لم تنجح في دمج العالم الإسلامي، ككلّ، في النظام الاقتصادي العالمي، بسبب ثنائية اقتصادها. الهدف الفسيح والذي لم يحدد بعد لاقتراب إسلامي من الاقتصاد يكمن في الإصلاح الشامل للإنسان في علاقته بالمجتمع، بالعالم وبالمحيط المادّي. الإستراتيجيات التي اُختيرت، تقليداً للمجتمع الغربي الاستهلاكي، يمكن تعويضها بمنظورات جديدة هادفة إلى تلبية سريعة للحاجات الأساسية لمعظم السكان، ومهتمة بمصير الإنسانية الوجودي. عبر هذه الرؤيا الأخلاقية، يمكن قلب معدل ـ وفي جميع الأحوال مضمون ـ التنمية في اتّجاه أو في آخر.
فقدان الاستقرار السياسي، الذي كابدته بلاد إسلامية كثيرة، لا يقدم الإطار الأفضل للتنمية الاقتصادية المتوقعة في مصطلحاتها العامّة والتقليدية من حاجات، من رغبات، من أمراض، من فقر ومن ثروات... إلخ. يوشك تفاعل القيم الأخلاقية، متطلبات النمو الاقتصادي والتكيفات البنيوية الناجمة عنها أن يقود إلى الكارثة، إذا ما كانت الاختلالات صارخة ولا سبيل إلى تصحيحها في الأبان. يمكن أن يكون لتنمية بالغة السرعة، أو فاقدة للتماسك، عواقب قومية أو إقليمية سلبية تماماً مثل الركود الدائم. فمنها يُنشأ عدم الاستقرار السياسي الذي يمنع، بدوره، التعاون بين شعوب الأُمّة الإسلامية، رغم أنّها تمتلك، ككلّ، موارد وفيرة ومتنوّعة. وفضلاً عن ذلك ينجم عن الصراعات بين الدول ثنائيات إقليمية وتدفع الممولين العامين أو الخاصين ـ وخاصة الشركات المتعددة الجنسية ـ إلى اختيار بلدان مأمونة ومشروعات قصيرة الأمد.
دمج البلاد الإسلامية في النظام الدولي ليس مشروطاً بمقاييس اقتصادية وحسب. فالعلاقة السياسية والتوازن العسكري الإقليمي تقودان أيضاً قوى السوق وتحددان أيضاً خيارات قد تؤثر سلباً أو إيجاباً على التصنيع، الزراعة أو النمو بصورة عامّة.
بإمكان زيادة التعاون الإقليمي أن يعطي نتائج حاسمة. ذلك أنّ العالم الإسلامي يمتلك تجانساً ثقافياً لا ينكر، وتكاملاً نسبياً في توزيع الموارد الطبيعية وبعض الكفاءات المالية. وبالتالي فأنّ أي مشروع تطوّر حقيقي سيصبح هيّناً إلى حد كبير بفضل تعبئة منسقة لمجموع موارده. ستجد الإمكانيات المتوافرة تحققها الأفضل، عندما تصبح تنميتها غير خاضعة لقرارات اتخذت في البلدان المصنعة وحدها، ذلك أنّ العلاقات التي أُقيمت في ظل السيطرة الاستعمارية ظلت قائمة لكن تحت أشكال جديدة.
ضرورة مراكمة رأس المال وتحريم القرض الربوي دفعت بعض الاقتصاديين المسلمين إلى البحث عن سُبل جديدة مبتكرة، محاولين تنسيق فائدة المدخرين والمستثمرين. فاقترحوا "مشاركة" منطوية، بطبيعة الحال، على اقتسام المخاطر والفوائد، بدلاً من القرض الربوي. تساءل بعضهم عمّ إذا كان إلغاء الفائدة المصرفية، في اقتصاد مازال موسوماً جدّاً بسمة الرأسمالية الغربية، لا يعني في الواقع تقديم المهم على الأهم، وعمّ إذا كان من الأفضل المبادرة أوّلاً إلى إدخال مجموع الاقتصاد إلى الإسلام. يمكن للنقاش أن يتواصل بدون نهاية. بيد أنّ المبادرة تبدو مفيدة، خاصّة إذا استطاعت أن تنجح في تعبئة الإدخار الصغير وتوظيفه ـ على نحو مفيد ـ في مشروعات تنمية من شأنها إن تتجاوب مع طلبات الشعوب الإسلامية على المدى البعيد.
تكمن الصعوبة الكبرى، رغم إمكان تذليلها، في دمج هذه المبادرة في النظام المصرفي العالمي. من الصعب أن تكون المصارف الإسلامية مختلفة جدّاً عن المصارف الأخرى. بيد أنّ المصرف الإسلامي قادر، على المدى المتوسط، على التصدّي لأحد الأعراض المرضية الأساسية التي لابدّ من القضاء عليها: واقع كون نمو بلدان العالم الثالث مشروطاً بتقدم الدول الصناعية! فبلدان منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية مازالت مركزاً لعملية المساعدة المالية والقروض التجارية، فهي ليست، بمقدار كبير، سوى وسطاء بين إدخار أجنبي وتوظيفات مرتبطة بشروط قاسية ومحكومة بمفهوم خاص للتطوّر الاقتصادي. المرور عبر الساحات المالية الغربية يُبقي على علاقات التبعية العمودية بين الشمال والجنوب، في الاتجاهين.
من أجل أن يكتب النجاح لمبادرة "المصرف الإسلامي" لابدّ لها من بلوغ هدفين اثنين في مستقبل منظور: من جهة، الحصول على جزء هام من الفوائض التي تتمتع بها البلدان المنتجة للنفط. إلّا أنّه لا ينبغي للمرء أن يغتر. فهذه المبالغ، مهما بدت هامة، لا تشكل سوى قطرة ماء بالنسبة لضرورات العالم الإسلامي المعاصر المالية. ومن جهة أخرى، فإنّ المصرف الإسلامي، بتعبئته للإدخار الخاص الصغير والكبير وبتجاوبه مع اهتمام المسلمين الروحي والثقافي، يصبح قادراً على التوليد التدريجي لروح الإدخار والميل إلى الاستثمار، بين فئات من السكان متعاظمة دائماً، خالقاً بذلك "مناخاً" اجتماعياً ضرورياً يساعد التقدم الاقتصادي على الانطلاق والنمو السريع. لابدّ أيضاً، من أن تكون هذه التوظيفات مربحة. وبالإمكان منح المصرف شكلاً أولوياً من الحماية، في مرحلة أولى، لكي لا يكون عليه أن يختار فقط بين المشاريع التي رفضها الممولون الغربيون الخاصون أو العامون بسبب المخاطر الكثيرة!. المبادرة مرضية فكرياً وجذابة أخلاقياً لكثير من المسلمين.
لابدّ من أن يستبدل بمحاسبي المصارف الغربية التقليديين محلّلون ماليون، قادرون على تقدير مخاطر وإمكانيات كلّ مشروع. المهمّة هي بوضوح مختلفة والمسؤولية ثقيلة. تكشف هذه الملاحظة عن لب المشكلة التي تواجهها، في جميع المجالات، حركة تأكيد الذات الإسلامية اليوم: التربية.
المصدر: كتاب الإسلام اليوم
مقالات ذات صلة
ارسال التعليق