- ١١ أيار/مايو ٢٠٢٤ | ٣ ذو القعدة ١٤٤٥ هـ
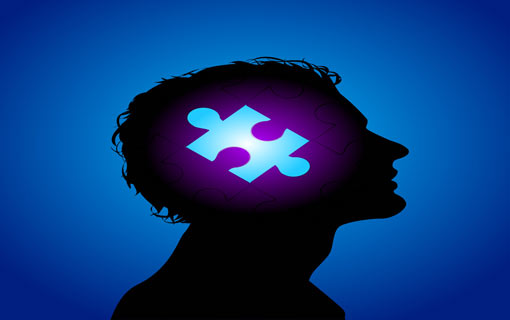
من الواضح للمتأمل في مسألة المعرفة في الإسلام؛ أنّ لها وجهاً آخر؛ يمكن إعادة النظر من خلاله بمقولة ابن حزم في أنّ المعرفة اكتسابية[1] في الإسلام:
(وَاللَّهُ أَخْرَجَكُمْ مِنْ بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ لا تَعْلَمُونَ شَيْئًا وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالأبْصَارَ وَالأفْئِدَةَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ) (النحل/ 78). (أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الأرْضِ فَتَكُونَ لَهُمْ قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ بِهَا أَوْ آذَانٌ يَسْمَعُونَ بِهَا...) (الحج/ 46). فما يظهر من هاتين الآيتين، وأمثالهما "تبين أن في الإنسان قوى مدركة للأشياء، وأن من هذه القوى: السمع والبصر والقلب؛ أي العقل[2]. وأنّ المعرفة الإنسانية تعتمد على هذه القوى؛ أي أنّها اكتسابية"[3]. ففي القرآن إذاً توجد نواة لنظرية المعرفة، اختلف حولها فلاسفة المسلمين أنفسهم، بملاحظة إننا نجد في القرآن الكريم اعتماداً واضحاً في تحصيل المعرفة الحسّية؛ على قوى الإحساس المباشرة. ما يوحي أنّ الظاهر من تلك الآيات كون هذه المعرفة اكتسابية، وفقاً لرأي ابن حزم، بمعنى أنها تكتسب من التجربة؛ أي من استخدام تلك القوى المدركة للإنسان في حقل وظائفها الطبيعية المخصصة لكل منها.. لكن السياق الواردة فيه تلك الآيات؛ هو الذي يحدد مضمونها ودلالتها. حيث يدل على أنّ المطلوب من المعرفة التي تؤديها القوى المدركة المذكورة؛ هو أن تقدم للعقل من مشاهد الكون وظاهراته العظيمة المحسوسة ما يدعم الإيمان الديني، ويثبت العقائد الإيمانية؛ مستفيداً من المعرفة الحسّية. هو – أي هذا الاهتمام – بحدّ ذاته يؤخذ لمصلحة العقل؛ لكونه إقراراً بضرورة دعم الإيمان بالعقل. لكن المسألة الآن هي: هل هذه الملحوظة تفترض القول بوجود نواة لنظرية المعرفة في القرآن؟ يبدو أنّها لا تفترض هذا القول؛ لأنّ الدلالة الإجمالية للآيات المذكورة؛ تضفي على المعرفة المكتسبة بوساطة قوى الإدراك الحسي؛ طابعها الإدراكي كحلقة في تسلسل عملية التفكير، تنقل الإدراك إلى حلقة لنصل إلى ذروة الاستنتاج المطلوب. وهو هنا: دعم الإيمان. كذلك ثمّة مسألة أخرى بشأن موقف الإسلام من المعرفة، لابدّ من النظر فيها، هي استيفاء للبحث، وإحاطة بمختلف نواحي الموضوع. والمسألة هذه هي: الظاهرة القرآنية التي تسمى ظاهرة "تمجيد العقل". وتقترن بها ظاهرة "تزكية الرسول للعقل في كثير من الأحاديث"، كما في تعبير بعض الباحثين المعاصرين[4]. إنّها مسألة تلفت النظر، وتستدعي المعالجة. ففي القرآن الكريم حشد متفرق من الآيات في تمجيد العقل: أمثال الآيات التي يُدعى فيها الناس؛ لاستخدام عقولهم في التفكير بمظاهر الكون، والاعتبار بما في السماوات وما في الأرض من عظيم الأسرار. وفي بعض الآيات تنديد بالذين لهم قلوب (عقول) (لَهُمْ قُلُوبٌ لا يَفْقَهُونَ بِهَا) (الأعراف/ 179)، وتشبيه هؤلاء بالأنعام: (بل هم أضل سبيلاً)[5]. فالقرآن إذاً، لم يتجاهل العقل، ولم ينكر وظيفته كأداة للتفكير، بل العكس هو الصحيح، كما تدل تلك الآيات الكثيرة. لكن، إلى أي مدى يُسمح للعقل أن يذهب في اكتساب المعرفة بنفسه؟ وثمة من يقول: إن كون مسألة المعرفة في الإسلام مقيدة بحدود معينة غير مسموح للعقل بتجاوزها؛ هو ما يجعل مسألة "تمجيد العقل" "في القرآن"، و"تزكيته في أحاديث الرسول" مسألة محددة الأفق كذلك. من هنا، يمكن مناقشة القول: إنّ السبب الوحيد في عدم إمكان طمس "الفكر العقلي في الحضارة العربية الإسلامية" إنما يعود إلى منابع الإسلام الأولى، إلى القرآن الكريم. وأنّ الفكر العقلي "لو كان موقفاً عارضاً، وأثراً من آثار التفاعلات التي اكتسبتها الحضارة العربية بمزاملة غيرها من الحضارات؛ لكان من الممكن طمس هذه الفسحة، أو زحزحتها من الميدان. لكن ارتباطها العضوي بالمصدر الأوّل المقدس للفكر الإسلامي بالقرآن، ثمّ تزكية الرسول للعقل في كثير من الأحاديث.. كل ذلك قد جعل من الفكر العقلي، ومن ثمّ الفلسفي، سمة أصيلة في الحياة الفكرية؛ يمكن أن تتراجع حيناً من الدهر، وتتخلف حقبة من الزمن، أو يصيبها الجزر فترة من الفترات، ولكنها تستحيل على الاقتلاع والزوال"[6]. يُناقَش هذا الكلام من أكثر من جانب، يناقش أوّلاً وأساساً: من جانب كونه يفصل بين مكونات "الفكر العقلي في الحضارة العربية الإسلامية"؛ أي بين مصدر الفكر الإسلامي، و"آثار التفاعلات التي اكتسبتها الحضارة العربية بمزاملة غيرها من الحضارات". فإنّ الموقف المنهجي يقتضي النظر إلى كل من هذين العنصرين كجزء عضوي تكويني في مركّب "الحضارة العربية الإسلامية". ومن هنا، أيضاً – ما هو مفهوم من هذا الكلام، من أن أثر التفاعلات المكتسبة من الحضارات الأخرى؛ يشكّل موقفاً عارضاً في "الفكر العقلي" لـ"الحضارة العربية الإسلامية" في حين أنّه يشكّل – كما قلنا – جزءاً عضوياً تكوينياً في وحدة هذا الفكر. ويُناقَش – ثالثاً – بأنّه مع ضرورة الاعتراف بالأثر العميق لـ"منابع الإسلام الأولى" في كينونة وحدة "الفكر العقلي" هذه، حيث ينبغي عند البحث عن السبب الحقيقي لاستحالة الاقتلاع والزوال لـ"تلك القسمة الأصيلة في الحياة الفكرية"؛ أن نكتشف هذا السبب في الحركة الاجتماعية؛ أي حركة تطور المجتمع العربي، وعلاقة الإسلام الموضوعية بها. وأخيراً يناقش من جانب كون منابع الإسلام الأولى؛ لا تسمح للعقل أن يذهب في اكتساب المعرفة؛ إلى أبعد من المدى المحدود الذي رسمته له طبيعة العلاقة بين المعرفة، والإيمان في الإسلام. وفي ضوء هذا النقاش بشأن مسألة المعرفة في الإسلام، وما يترتب عليها من جدل العلاقة بين الإيمان والمعرفة؛ أي العلاقة التي ربطت المعرفة بالعقائد الإيمانية على نحو من الارتباط المطلق؛ نجد أنّه من الضروري إعادة النظر في سؤال: - هل تعني هذه الاستنتاجات والمناقشات أنّ انقطاعاً حدث في مجرى تطوّر الفكر العربي؟ أو توقّفاً عن الحركة في هذا المجرى أثناء العهد الأوّل للإسلام؟ إنّ صيغة السؤال – هذه – تشير إلى أنّه كان هناك مجرى متحرك للتطور يجري فيه الفكر العربي قبل الإسلام، وأنّ هذا المجرى كان يمضي في حركته مع حركة التاريخ. فهل ذلك صحيح؟ الواقع أنّ الفكر العربي كان يتحرك في مجرى التطور التاريخي، فعلاً خلال الفترة الجاهلية القريبة من ظهور الإسلام، وكانت حركته أنذاك تشمل الجوانب والتصورات الدينية الميتافيزيقية منه. ولم ينكر هذا الواقع أحد من المفكرين الإسلاميين من قدماء ومعاصرين، فقد رأينا أمثال الشهرستاني، والقاضي صاعد، وابن خلدون، ومصطفى عبدالرزاق. يتحدثون عن مظاهر ثقافة جاهلية، وعن طبيعة التفكير التي تسود هذه الثقافة، ويذكرون من هذه المظاهر ما يتعلق بميتافيزيقيا الوجود. ويستوقفني النظر بصدد ذلك قول عبدالرزاق: إنّ العرب كانوا "حين نزول القرآن" في منازعة، وجدل في العقائد، وكان البحث في إرسال الرسل، والحياة والآخرة، وبعث الأجساد بعد الموت؛ موضع الأخذ والردّ على الخصوص بين النحل المتباينة"[7]. كان الفكر العربي إذاً، يتحرك في الجاهلية، في مجرى التطور، ولم تكن مسألة المعرفة قد ارتبطت عند (مفكري) الجاهلية أو (حكمائها) بمصدر محدد ونهائي؛ كما ارتبطت في العهد الأوّل للإسلام؛ أي لم تكن قد وجدت هذه العلاقة بين الإيمان والمعرفة. ومن هنا، صحّ أن نفتح السؤال السابق بصيغته المعينة تلك؛ لأنّه أصبح من حقّ الباحث أن يتصور بعد ارتباط مسألة المعرفة بالإيمان؛ أن شيئاً من الانقطاع أو التوقف قد حدث في مجرى تطور الفكر العربي. فكيف ننظر في هذه المشكلة؟ إنّ خطأً مثل هذا التصور يكمن في النظر أحادي الجانب؛ إلى العلاقة الإسلامية بين المعرفة والإيمان؛ بمعنى النظر إلى هذه العلاقة بذاتها منفردة ومنعزلة عن سائر العلاقات التي تتصل بحركة المعرفة في أوائل عهد الإسلام، أو بمجمل الظاهرات التي تشكّل المجرى العام الجديد، لحركة تطور الفكر العربي – الإسلامي. فإنّ المعرفة – الإيمانية أو الإيمان – المعرفي، أو العلاقة المركبة منهما؛ هي مسألة ليست منقطعة عن الشكل التارخي لتطور المعرفة في عصر الجاهلية؛ أعني أن ارتباط المعرفة بعالم ما وراء الطبيعة، ليس غريباً عن توجهات الجاهلية الأخيرة؛ منذ انتشار ظاهرة الحنفاء. هذا أوّلاً. وثانياً: إنّ ظهور الإسلام في الظروف التاريخية وضع هذا الشكل التاريخي للمعرفة في سياق حركة واقع اجتماعي؛ كان يتغير، ويستقطب جملة الظاهرات التي تتطلب الضرورة التاريخية. وقتئذ، وصَهَرها جميعاً في إطار حركة التغير هذه. فإذا نظرنا إلى مسألة المعرفة ضمن هذا السياق؛ أي في حقل الحركة الشمولية تلك، فسوف لا نرى في ارتباطها الإيماني انقطاعاً عن مجرى تطور الفكر العربي؛ لأن هذا الارتباط لم يأتِ منعزلاً عن حركة التطور الشاملة، بل إنّه كان أحد التعبيرات التي اقتضتها الضرورة التاريخية المشار إليها. ومن خلال هذه الرؤية لابدّ أن نلحظ أنّ المضمون العام للفكر العربي في صدر الإسلام؛ أخذ يتجاوز مرحلة البساطة والحسية اللتين كانتا مسيطرتين عليه بوجه عام؛ إلى مرحلة يسودها التركيب والتعقيد. وهي مرحلة تنتقل خلالها عملية المعرفة، في إطار التصور الحسّي الغالب، إلى إطار من التجريد الذهني بصورة نسبيّة. ولا شكّ في أنّ المفاهيم الإسلامية المتعلقة بما وراء الطبيعة بالأخص؛ تشكّل حلقة الانتقال تلك. من هنا، يصح القول: إنّ الفكر العربي أخذ يشقّ طريقه عبر التحامه بالمفاهيم الإسلامية، نحو وضع نوعي، متقدم نسبياً. وسنرى وتيرة تقدمه تتصاعد؛ كلما حدث تغير نوعي في حركة تطور العلاقات الاجتماعية على صعيد المجتمع الذي ينبسط عليه سلطان الدولة العربية – الإسلامية[8]. ولا يزال جدل العلاقة بين العقل والدين مصدراً من مصادر المطارحات الإسلامية – الإسلامية، بل مصدراً من مصادر التصارع داخل المذهب الواحد. وبالرغم من اشتهار مقولات: إنّ العقل أنموذج من نور الله، وأنّه وكيل الله عند الإنسان، وأنّه حجة الله... في أدبيات فقهاء الإسلام، إلا أنّ إشكالية العقل والنصّ لا تزال ملتبسة في تحديات الاتساق بين النظر العقلي والإيمان الشرعي. فانتهت المعتزلة إلى قاعدة أساسية في معرفة الله؛ وهي أن أول ما أوجب الله علينا: النظر المؤدي إلى معرفته تعالى. وهنا يفترق عنهم الأشاعرة الذين أوجبوا هذا النظر بعد المعرفة السمعية؛ بمعنى أنّه ليس على المكلف أيّ واجب لأداء النظر، إلا بعد أن يبعث الله الرسول (ص) بمعجزاته، فيجب على المكلّف عندئذ النظر في هذه المعجزة، ثمّ تحصل له المعرفة بالله، بالضرورة والعادة[9]. ويبدو لي أنّ الأزمة الكلامية والفلسفية عند المسلمين هي أزمة الاتفاق على مفهوم (العقل)، وتعريفه، فنشأ ما نشأ من مشكلات لا تزال عالقة في مناهج الحوار الإسلامي – الإسلامي، ولا تزال الأسئلة ذاتها مفتوحة على سجالات العلاقة بين الدين والدولة، وبين الدين والمجتمع. فهل العقل واحد أم متعدد؟ وهل النقد علامة على قوة العقل؟ أم على ضعفه؟ وما علاقة السياقات الاجتماعية والحقب التاريخية بالعقل؟ هل هي عوامل لتغييره؟ أم أنّ العقل كيان لا يتغير ولا يتطور؟ ولمّا كان الدين موضوعاً جوهرياً لفلسفة الوجود، فكيف يمكن للنقد أن يربط العقل بالدين؟ وهل يمكن للعقل أن يكون حكماً على الدين وما حدود حاكميته؟ وهل تتطابق حدود الدين؟ مع حدود العقل؟ أم إنّ أحدهما يتخطى الآخر؟ غير أنّ السؤال المطروح بقوة هو: هل تنتهي مهمة العقل الإسلامي عند مهمات التحقق من صحة النصوص الدينية؟ أم إن وظيفته يجب أن تطال جميع ميادين المعرفة الدينية؟ بما فيها الأصول التي تشاد عليها العقيدة نفسها؛ ليصبح المقدس هذه المرة ليس هو الدين المجرد من العقل، وليس هو العقل المجرد من الدين، وإنما الحقيقة التي يتمّ اكتشافها من مزاوجة العقل والدين على قاعدة الاستعمال السليم للعقل، وعلى قاعدة الوعي السليم للدين. ولا يمكن فهم قاعدة السلامة هذه من غير أن يتعلق منهج القاعدة بالثوابت المعيارية لسلامة الاجتماع البشري، فلا تبني أي تفسير ديني أو عقلي ينزع إلى الإضرار بالمجتمع. وتلك هي المعادلة الصعبة لدين العقل، وعقل التدين. فليس من الدين بشيء تمجيد التدين الطقوسي الأعمى، وليس من التنوير العقلي بشيء تسفيه الدين. من منظور ثقافة الاجتماع الديني الغربي رفض كانط أن تكون المواضيع الدينية الجوهرية؛ مثل الله، وخلود النفس، وحرية الإنسان... قابلة للمعرفة النظرية؛ لأنّها ببساطة أشياء غير خاضعة في ذاتها لأطر المعرفة الحسية من زمان، ومكان، وعليّة؛ ولذلك جعلها في مستوى مسلمات العقل العملي الذي يبنى عليها الواجب الخلقي. والسؤال التحدي هو: إذا كان الإنسان هو الجذر الحقيقي لكل من الدين، والسياسة، والحقوق... فلماذا لا نستعيد أفكار تصحيح النقد من نقد استفرغ كل ما عنده في نقد الدين، والسماء؛ إلى نقد لا يزال حذراً – بفعل السياسة، إلى نقد السياسة. كذلك يرى الفيلسوف الألماني يورغن هابرماس من منطلق الدفاع عن التعديدة أن على المجتمع المعلمن والديمقراطي؛ أن يولي السنن الدينية المعترف بها أكثر من مجرد مكانة يتركها لها أدب المعاملات، أو احترام عراقتها. فما يتسنى للأديان أن تقوله للمجتمع، وفي المجتمع؛ ليس أقل قيمة أو أهمية من خطاب العلم، أو المعرفة الدنيوية عموماً. وعنده لا يحقّ للمعلنين عندما يحسنون القيام بوظيفتهم السياسية إنكار الحقيقة الكامنة في الصور الدينية للعالم، كما لا يحق لهم أن يرفضوا حقّ المؤمنين في تقديم إسهاماتهم في النقاشات العمومية بلغة دينية. بل يذهب – يورغن هابرماس – إلى أبعد من ذلك عندما يترقّب من المواطنين المعلنين من منطلق ثقافة سياسية ليبرالية؛ المشاركة في بذل جهود من أجل تحويل الإسهامات – القيّمة – من لغة دينية، إلى لغة يمكن أن يفهمها الجميع[10]. ومن جهة أخرى يدعو الفاتيكان إلى أهمية دَوْر العقل بوصفه مصححاً للباثولوجيا الدينية، ويعترف بأن رجال الدين المسيحيين قد التجأوا إليه في فجر الحداثة، وغايتهم من ذلك إيجاد أرضية تفاهم مشتركة بين أهل المذاهب المتطاحنة، وبين المتدينين وغير المتدينين. الهوامش:[10]- التعددية والأخلاق، مجلة فرنسية شهرية، 2004 E Sprit Juillet P.P. 6-18. نقلاً عن: التنوير والعقل والدين، للباحث محسن الخوني، جامعة تونس.
المصدر: كتاب إجتماعيات الدين والتدين (دراسات في النظرية الاجتماعية الإسلامية)
مقالات ذات صلة
ارسال التعليق